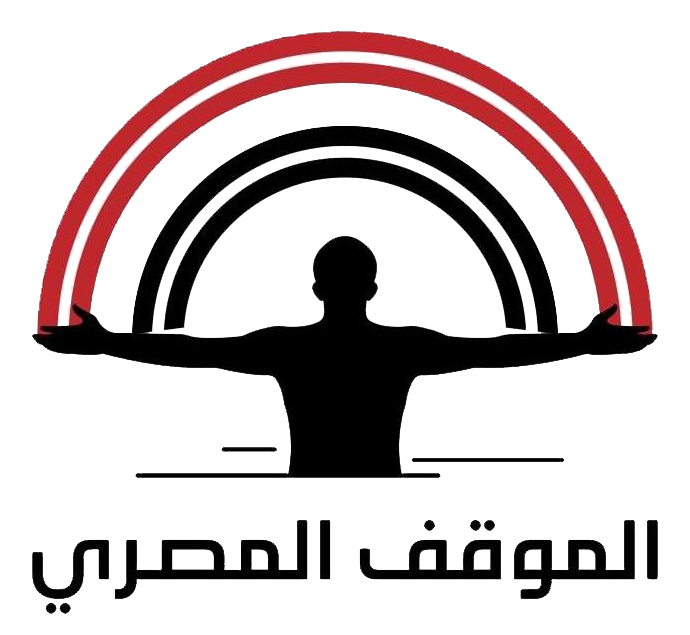التعديلات الدستورية اللي هنستفتي عليها الأسبوع ده من أخطر التعديلات اللي مرت علينا طول تاريخنا الدستوري.
اللي يقرأ نصوص دساتيرنا من أول دستور ٢٣ مش هيتعب في اكتشاف إن دساتيرنا كلها كانت بتوضح وتوسع من صلاحيات الدولة، ورئيس الدولة تحديدا، سواء كان ملك أو رئيس جمهورية، أكتر من كونها بتحمي المواطن أو بتدافع عن حقوقه.
لكن كله كوم، والتعديلات المطروحة علينا دا الوقت كوم تاني.
التعديلات في جوهرها بتتعلق بثلاث حاجات:
١. تمديد مدة رئاسة السيسي علشان يفضل في الحكم لسنة ٢٠٣٠ (المادة ١٤٠ و٢٤١ مكرر) وإعطاؤه حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الجديد (مادة ٢٥٠)
٢. السماح للقوات المسلحة بالتدخل في السياسة (يعني القيام بانقلاب عسكري) بدعوى “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” (المادة ٢٠٠)
٣. القضاء على استقلال القضاء، ودا عن طريق إعطاء السيسي حق تعيين رؤساء الجهات القضائية (مادة ١٨٥)، وحق تعيين رئيس المحكمة الدستورية (مادة ١٩٣) وحق تعيين النائب العام (مادة ١٨٩) وتقليص دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين (مادة ١٩٠).
الملاحظ في التعديلات دي إنها ما بتخصناش، إحنا كشعب. ما فيش كلام عن حقنا في التعليم ولا الصحة ولا الحياة الكريمة ولا الخصوصية ولا حقنا في حكم نفسنا بنفسنا (اللهم إلا مادة ١٠٢ المتعلقة بكوتة المرأة في مجلس النواب).
إحنا كشعب مش معنيين بالتعديلات دي. ولا التعديلات دي تخصنا أصلا.
دي تعديلات في طبيعة علاقة أجهزة الدولة بعضها ببعض، وخاصة علاقة مؤسسة الرئاسة بالجيش.
دي علاقة قديمة ومأزومة ولها تاريخ طويل يبدأ من أول ما ضباط يوليو قاموا بانقلابهم سنة ١٩٥٢.
مهم إننا نتعرف على ملامح الأزمة التاريخية دي من غير دخول في تفاصيل.
باختصار، عبد الناصر وزمايله من الضباط الأحرار وقعوا في حيص بيص بعد ما نجحوا في انقلابهم ليلة ٢٣ يوليو. التخلص من الملك سهل. والقضاء على الوفد برضه سهل. حتى التخلص من الإنجليز ومن الإخوان كان سهل.
المشكلة الأكبر كانت الجيش اللي هم نفسهم جم منه. السؤال الصعب كان: إزاي نضمن، بعد نجاحنا في الانقلاب، إن الجيش ما ينقلبش علينا إحنا؟ دا ما كانش سؤال نظري، إنما كان سؤال ملح. سوريا اتعمل فيها ثلاث انقلابات في سنة واحدة، سنة ١٩٤٩، يعني قبل انقلاب يوليو بثلاث سنين بس. (وبالتالي فشعار “علشان ما نبقاش زي سوريا” شعار قديم وله تاريخ طويل).
الحل كان “تأمين الجيش”، يعني منع الجيش من إنه ينقلب على ضباط الانقلاب. ودا تم عن طريق إحالة عدد كبير من كبار الضباط للتقاعد، والقبض على كتير غيرهم، وأهم من دا ودا، تسليم الجيش لواحد منهم، علشان “يأمنه”. وطبعا والواحد دا كان عبد الحكيم عامر، الضابط الإمعة اللي عبد الناصر صمم على ترقيته أربع رتب دفعة واحدة علشان يبقى قائد الجيش.
والنتيجة؟ النتيجة كانت إن عبد الحكيم حول الجيش لعزبة ليه ولأصحابه، وأسس فيه قاعدة لشعبيته ولمعارفه، وكون “دولة داخل الدولة” باستخدام مصطلحات وقتها، ومنع عبد الناصر ومؤسسة الرئاسة من التحكم في الجيش. وفضل الحال على ما هو عليه من سيطرة عبد الحكيم على الجيش وسيطرة عبد الناصر على الرئاسة لحد ما البلد اتقسمت اتنين: عبد الناصر عنده الشارع، وعبد الحكيم عنده الجيش. عبد الناصر رئيس الجمهورية، وعبد الحكيم رئيس الجمهورية بشَرطة. وطلعت النكتة الشهيرة إن ج. ع. م. اللي هو الاسم المختصر للجمهورية العربية المتحدة، هو في الحقيقة اختصار لـ “جمال، عبد الحكيم، مناصفة”.
التناحر دا بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش أدى لمحاولة كل مؤسسة منهم إنها تنشئ أجهزة أمنية واستخباراتية خاصة بيها، وكل جهاز يتجسس على التاني. فالمخابرات الحربية بتاعت عبد الحكيم تتجسس على عبد الناصر، فيقوم عبد الناصر بتأسيس مكتب الرئيس للمعلومات والتنظيم الطليعي في الاتحاد الاشتراكي علشان يتجسس على عبد الحكيم.
والنتيجة؟
كارثة ٦٧.
بعد الكارثة دي، الرئاسة أخيرا عرفت تهزم الجيش، وعرفت تفرض سيطرتها عليه. أخيرا تمكن عبد الناصر من التخلص من المشير ورجالة المشير، وعرف يعين رجالته هو في الرتب العليا في الجيش، وأصبح الجيش تابع للرئاسة مش خارج عن سيطرتها. وبدأ النظام من وقتها في الاعتماد على الداخلية لحمايته من الشعب. فمش صدفة إن عبد الناصر أسس قوات الأمن المركزي اللي هي جزء من الشرطة سنة ١٩٦٨ لما نزلت المظاهرات تهتف ضده بعد الأحكام المخففة بتاعت محكمة الطيران.
السادات كمل اعتماده على الشرطة لحماية نظامه، وكان من أهم علامات الاعتماد دا تعيين ممدوح سالم، وزير الداخلية السابق، رئيس وزرا سنة ١٩٧٥.
ولكن الأهم هو نجاح السادات في إقصاء الجيش من أي دور أساسي في الحكم، حتى بعد انتصار أكتوبر. فكل قادة أكتوبر اتمنعوا من استثمار انتصارهم العسكري وتحويله للعمل السياسي. مين مننا يقدر يذكر اسم أي قائد من قادة العبور عرف يبني لنفسه كارير سياسي اعتمادا على سجله العسكري؟ محمد صادق؟ إسماعيل علي؟ كمال حسن علي؟ الجمسي؟ الشاذلي؟
وعلشان يضمن ولاء ضباط الجيش ليه أنشأ السادات سنة ١٩٧٩ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللي سمح للجيش إنه ينشئ شركات خاصة بيه معفاة من الضرايب ومن الرقابة البرلمانية أو الإدارية أو الصحافية، بدعوى تعزيز الاكتفاء الذاتي للجيش، وإنما في الحقيقة علشان يعطى لضباط الجيش مزايا ووظايف بعد ما يتحالوا ع المعاش.
لما تولى مبارك الحكم بعد اغتيال السادات فضلت العلاقة المأزومة دي بين الرئاسة والجيش من أهم ملامح رئاسته العقيمة الل امتدت تلاتين سنة. العلاقة المأزومة دي ناس كتيرة عبرت هنا باستخدام مصطلح “علاقة الرئيس بالمشير”، واللي كان أهم فصل من فصولها علاقة مبارك بعبد الحليم أبو غزالة، واللي انتهت بعزل الرئيس للمشير سنة ١٩٨٩
بعد مؤسسة الرئاسة ما نجحت في القضاء على المشير أبو غزالة نجح مبارك أخيرا في إقامة سلام بارد مع مؤسسة الجيش عن طريق ثلاث وسائل: ١. تعيين المشير طنطاوي كوزير دفاع مضمون ومطيع؛ ٢. توسيع صلاحيات جهاز الخدمة الوطنية لضمان ولاء ضباط الجيش؛ ٣. توسيع صلاحيات الداخلية وأمن الدولة تحديدا تحت رئاسة حبيب العادلي علشان تكون قطب مناوئ للجيش. لكن فضل الجيش مُستَبعد من مركز الحكم.
كل دا واحنا قاعدين.
إحنا، كشعب، ما لناش لا في الثور ولا في الطحين. أسياد البلد بيتخانقوا فيما بينهم على مين ياخد إيه. الجيش عرف يبنى امبراطورية اقتصادية بعرقه (مش بدمه)، والشرطة توسعت في سيطرتها علشان عارفة إن أمن النظام مرتبط بيها هي.
لحد ما وقعت الواقعة.
في ٢٥ يناير ٢٠١١، بعد ستين سنة من بداية الصراع بين الرئاسة والجيش والداخلية، أسياد البلد فجأة انزعجوا لدخول عنصر رابع: الشعب.
الناس لما نزلت في ٢٠١١ أسياد البلد اتخضوا، واعتبروا إن ثورة يناير شكلت تهديد وجودي ليهم أكتر من التهديد اللي شكلته إسرائيل سنة ٦٧.
“انتم مين؟” دا كان لسان حال أسياد البلد لما شافوا الجماهير في الشوارع والميادين. “إيه اللي وداهم هناك؟”
الناس لما نزلت عرفت تزعزع ركنين من الأركان الثلاثة بتاعت دولة يوليو العقيمة: الداخلية يوم ٢٨ يناير، والرئاسة يوم ١١ فبراير.
لكن الركن الثالث استعصى عليهم. الجيش فضل رابض في الدرة لحد يوليو ٢٠١٣ لما لقى فرصة ذهبية لاستعادة مكانته المميزة اللي فقدها في ٦٧.
لكن المرة دي الغرض مش إنشاء دولة داخل الدولة، إنما السيطرة على الدولة بكل مفاصلها.
دا الوقت الجيش مسيطر على الرئاسة، والداخلية بقت تابعة وخاضعة ليه.
المشكلة في حاجتين: القضاء اللي ممكن يعك الطبخة ويغير من موازين القوى، ولو بشكل طفيف.
وشوية الميت مليون مصري اللي تجرأوا وطالبوا بإن يكون ليهم صوت في إدارة البلد، قال إيه بدعوى إنهم مواطنين وأصحاب البلد الحقيقيين.
من هنا ممكن نفهم هدف التعديلات الدستورية دي. الغرض أعمق وأخطر من السيسي. الغرض هو التخلص من رواسب الفكرة الجمهورية برمتها.
دولة يوليو، زي ما اتقال كتير، كانت من يومها جمهورية بلا جمهور.
لكن من حين لآخر الجمهور دا بيحاول يثبت وجوده ويعمل راسه براس أسياد البلد. حصل دا في ١٩٦٨، وفي ١٩٧٢، وفي ١٩٧٧، وفي ١٩٨٦، وفي ٢٠١١.
وبالتالي لازم نحط حد لمحاولات الحثالة دي إنها تهدد استقرار البلد. لازم حل حاسم يغير من طبيعة النظام الجمهوري كله.
شبه الدولة دي اللي بتفتح المجال للناس إنها تتعالى على أسيادها لازم تتحول لدولة لها سيادة وهيبة.
وعلشان دا يحصل لازم الرئاسة والجيش والداخلية ينصهروا في بوتقة واحدة بشكل يوحد طوايف الدولة ويقويها.
ولازم القضاء يلزم مكانه.
وقتها الميت مليون مصري ممكن يتحكموا ويتقمعوا زي العبيد.
لكن فيه مشكلة صغيرة.
علشان التعديلات دي تتم، لازم نطلب من العبيد دول إنهم ينزلوا الشارع، يمكن لآخر مرة في حياتهم، علشان يعطونا الحق في التخلص منهم.
الصحافة كممناها. والبرلمان وضبناه. النقابات أممناها. الجامعات ضيعناها. جمعيات حقوق الإنسان نسفناها.
فاضل بس القضاء اللي ممكن الناس تحتمي بيه. وفاضل كمان الضوء الأخضر اللي لازم نعطيه للجيش علشان يتدخل في السياسة زي ما هو عاوز.
هو دا الهدف من التعديلات الدستورية.
علشان كده تحديدا لازم ننزل ونقول لأ، بكل قوة وبأكبر عدد. لأن ببساطة التعديلات دي معناها إننا نبقى عبيد بلا دية.